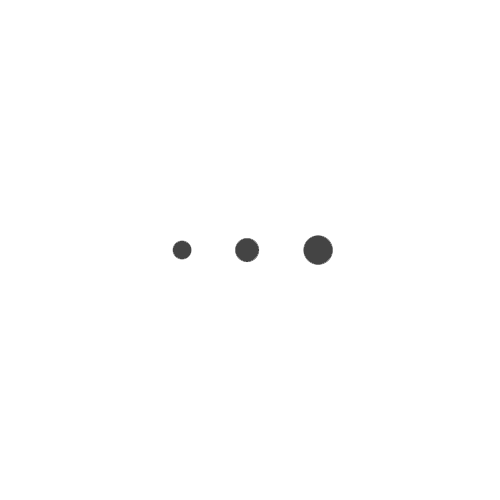في جُحر الأرنب
دهاليز السجون اللبنانية
جورج حداد
وفقاً لمعايير الشرق الأوسط، يتّسمُ المجتمع اللبناني بأنه مجتمع حيوي ومدمِّر وحُرّ ... إلى حد ما. أينما وقعت عيناك تجد رجالاً ببزاتٍ يحرسون كل مكان مدعومين بكاميرات أمنية على نحو متزايد، إذ يمكن لمظاهرة صغيرة من بضع مئات من الأشخاص أن تستدعي نشر الآلاف من رجال الشرطة (أو الدرك) وكذلك الجيش، وقد يُستجوب أيّ أحد دون سبب واضح، أحياناً من قبل ضباط يرتدون ملابس مدنية يظهرون على حين غرّة. كما أنّ اللاجئين والعمال المهاجرين على وجه الخصوص عرضة للاستجواب في أية لحظة. أما سجن رومية، أكبر سجون البلاد، فهو بعبع يأتي ذكره بسهولة بين الأصدقاء لإخافة مَن يوشك أن يتجاوز ما يرونه خطّاً أحمر: "لا تريد أن يعثر عليك والدك في سجن رومية، أليس كذلك؟" كما اكتسب مخفر حبيش، وهو مركز شرطة يبدو عادياً في حي الحمرا في بيروت، سمعة مخيفة على نحو مماثل.
إن إمكانية التعرض للتوقيف والاعتقال حاضرة بقوة في الوعي الجمعي للبنانيين، غير أن هذا الحضور يظل أمراً مجرّداً، إذ يتجاهل عامة اللبنانيين عدد المعتقلين والظروف المزرية التي يعيشون فيه والاستخدام المُمنهج للتعذيب. كما تتجاهل كُبريات وسائل الإعلام الموضوع بشكل عام، في حين يعامل المجتمع ككُل حالات محددة على أنها من المحرّمات: سيختفي الأشخاص الذين اعتقلوا في ثقب الاحتجاز الأسود، وعندما يعودون مرة أخرى، يرمون هذه التجربة القاتمة خلف ظهورهم. شهادات المعتقلين السابقين نادرة ويصعب الحصول عليها، وقد جعل هذا الغموض ومعاملة المعتقلين اللّاإنسانية قطاع السجون في لبنان أسوأ بكثير مما يفترضه معظم الناس، ما جعل لبنان يقترب بشكل خطير من أن يصبح أشبه بأي نظام عربي آخر. إن الغوص عميقاً في هذا الأمر أشبه بقصة أليس في بلاد العجائب عندما هَوَت في عالم يحكمه العبث.
"كنا في طريقنا لشراء بعض الأواني، وفجأة أوقف صديقي السيارة عندما رأى نقطة تفتيش للجيش. كنتُ ثملاً، لكنني صحوتُ وأخبرته أن يعود أدراجه، فصوّب الجنود أسلحتهم نحونا وراحوا يصرخون. أمرونا أن نترجّل من السيارة وأن نستلقي على الأرض ودفعونا بعنف، وجعلونا نخلع ثيابنا في وسط الشارع، بدءاً بملابسنا ثم أحذيتنا، وصولاً لملابسنا الداخلية. كان الأمر مخيفاً. عندما يحدث شيء من هذا القبيل، فإنك تصحو حتى إن كنت ثملاً وتعود إلى رشدك."
بعد وفاة أحد أقاربه، تحوّل طوني إلى مدمن على المخدرات والكحول، ثم انتهى به الأمر في السجن. كان في السابق صريحاً رحب الصدر، لكنه الآن خجول ويعتريه القلق، وينتقي كلماته بعناية لوصف تجربته التي حولته إلى إنسان آخر رغم أنها اقتصرت على ثلاثة أشهر من الاحتجاز.
"عثر جندي على 0.8 غرام من الحشيش أخفيتها في علبة سجائر، فصفعني وأهانني وقيدني ورماني في سيارة جيب، ثم أخذونا إلى ثكنات ووضعونا في صندوق شاحنة خارج المبنى مع موقوفين آخرين. كان الناس يتبولون على الأرض ويتقيؤون ... كان الأمر مروعاً. في إحدى اللحظات، أثناء الاستجواب، سألني جندي عما إذا كنتُ أستخدم علبة العدسات الخاصة بي لنقل الكوكايين، ثم ضربني لكون جوابي "غير محترم". طلبتُ التحدث إلى والدي، لكنهم رفضوا بالرغم من أنّ القانون ينصّ على أن للموقوف الحق في الاتصال بأحد الأقارب أو المحامين. لا أحد يعرف أين كنت. من حقك أيضاً أن تلتزم الصمت، لكن بالطبع هذا لن ينجيك من الضرب."
إن إمكانات تحسين هذا القطاع هائلة، فما يفتقر إليه قطاع السجون اللبناني في الاهتمام الشعبي الواسع يُعوَّض بمواردَ تخصصها له مجموعةٌ من المنظمات غير الحكومية اللبنانية والدولية التي تعمل جنباً إلى جنب مع السفارات الغربية المختلفة والأمم المتحدة. تُعِدّ هذه المنظومة من الجهات الفاعلة تقاريرَ وتعقد مؤتمرات وورش العمل وتقدم توصيات من أجل الإصلاحات و "بناء القدرات" وإعادة تأهيل السجون ومجموعة من القضايا ذات الصلة. لكن مشكلات قطاع الاعتقال في نهاية المطاف تتعمق إلى حد كبير لدرجة أن هذا العدد الكبير من المشاريع لا يُظهر تأثيراً ضئيلاً فحسب، بل قد يساعد النظام على الاستمرار في التعثر القائم.
سبيل غير واضح
تتركز الموارد الكبيرة المخصصة لإصلاح قطاع السجون في لبنان، قبل كل شيء، على مشكلتين: بنية النظام التحتية المادية شديدة الضعف من ناحية، والاستخدام واسع النطاق للتعذيب من الناحية الأخرى. تتمحور النقطة الأولى حول قضية الاكتظاظ في المقام الأول، وهي مشكلة جوهرية غالباً ما يُعزى لها الكثير من أوجه القصور الأخرى، وتُعتبر مصدر قلق كبير لمجموعة واسعة من المعنيين، بمن فيهم العاملون في المنظمات غير الحكومية وقوات الأمن والمسؤولين الحكوميين والزعماء الدينيين والسجناء السابقين والمحامين، هذا إن لم تكنِ المشكلةَ الكبرى في هذا القطاع. يرى الكثيرون بأن هذا الأمر اكتسب أهمية متجددة بسبب تدفق اللاجئين السوريين الذين أكد قاضٍ لبنانيٌّ أنهم يمثلون ربع إجماليّ عدد السجناء.
ولا شك في أن عدد السجناء يتجاوز بشكل كبير العدد المعلن رسمياً والبالغ 3500 معتقل. البيانات الدقيقة غائبة كلياً، غير أنّ محامياً لبنانياً مخضرماً قال إن هناك أكثر من 5000 معتقل في سجن رومية فقط، في حين حدد مسؤول في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي العدد الإجمالي للسجناء بين 6000 و 6500. يصرّ بعض السجناء السابقين على أن العدد الإجمالي أكبر من ذلك. أحدث الأرقام من الإدارة المركزية للإحصاء - والتي يعود تاريخها إلى عام 2010 الذي كان عاماً هادئاً ومزدهراً على غير العادة – هي أرقام غير مكتملة ومُبهمة، غير أنها أفادت بحدوث 17501 عملية توقيف و 7461 نزيلاُ جديداً في سجن رومية (في حين أُطلق سراح عدد مماثل من السجناء) .يتفاقم الاكتظاظ الشديد بسبب تدهور البنية التحتية القائمة
ما يفاقم الاكتظاظ الشديد بدوره هو تدهور البنية التحتية القائمة، فمعظم زنزانات السجون لا تحتوي على تدفئة أو تكييف هواء، ويفتقر العديد منها للتهوية المناسبة وضوء النهار والفِراش والصرف الصحي، وعادة ما يُحشر عشرات الأشخاص في غرفة قاحلة شديدة الصغر لدرجة أنهم لا يستطيعون الاستلقاء جميعاً ويتناولون وجبة واحدة يومياً ويتشاركون حماماً واحداً. يظل بعض السجناء شهوراً في زنزانات شديدة الاكتظاظ بحيث يستحيل عليهم الاستلقاء.
علاوة على هذه المعاملة اللاإنسانية، يتعرض معظم المعتقلين للتعذيب الجسدي المباشر الذي يشكل الركيزة الثانية للنهج السائد. يشمل العنف ضد السجناء الضربَ المتكرر، خاصة خلال المراحل المبكرة بُعيد الاعتقال؛ ولاحقاً سيعاني العديد من المعتقلين من صنوف اضطهاد أكثر تعقيداً، فعلى سبيل المثال، زعم سجين سابق أن الدرك أجبروه على خلع حذائه وجواربه والوقوف حافياً في غرفة مملوءة بالماء وراحوا يصعقوه بالكهرباء. ووصف مدان سابق آخر الفروج أو "الدجاجة"، حيث عُلق في السقف ورأسه للأسفل لخمس ساعات تعرض خلالها للضرب المتكرر.
"جاؤوا في منتصف الليل. حدث الأمر بسرعة، وبالكاد كان لدي الوقت لأرتدي ملابسي. كانت والدتي تبكي، وكان إخوتي مرتبكين للغاية." يتحدث ميشيل، المثقف والفنان والموظف المنتِج لساعات بطاقة لا تهن عن السنوات الثماني المظلمة التي قضاها في الاحتجاز. "لقد رموني في سيارة جيب حيث بدأت الإهانات إلى جانب بعض الصفعات. في تلك اللحظة لا يفارقك الشعور بأن هناك مخرجاً ما، وأن كل شيء سيكون على ما يرام. ثم تصل إلى المخفر [أو مركز الشرطة]، لا تستطيع البكاء، لكنك خائف ومذعور. من المستحيل وصف حالتك الذهنية ما عدا "ما الذي يحدث لي بحق السماء؟"
بقيتُ هناك ثلاثة أيام. إنها أشبه باللحظة التي تسبق حادث سيارة، لكنها تستمر إلى الأبد. يريدون أن يكسروك. كنتُ معصوب العينين طوال الوقت، لذا لم أكن أعرف من أين كانت تأتيني الضربات. تتألم، ثم يتملكك الذعر. وضعوني في غرفة بلا نافذة ولا مصباح. لم أكن أعرف الوقت الذي أنا فيه، أو ما إن كنت مستيقظًا حقًا أم لا. قلةُ النوم والضربُ والإذلالُ تجعلك تفقد الاتصال بالواقع. لقد كنت تائهاً.
في مرحلة ما، نقلوني إلى غرفة أخرى، وجعلوني أخلع قميصي وأمدّ يديّ عبر نافذة حيث قام عنصر من الدرك على الجانب الآخر بتقييدهما حول عمود. وهنا بدأ الأسوأ. قاموا بجَلدي بحبال صيد في نهايتها قطع حادة من الرصاص. لا أتذكر كم استمر الأمر، لكنهم ضربوني أكثر من مئة مرة. ما زلتُ أتذكر قهقهاتهم وإهاناتهم ورائحة العرق في غرفة ذات ضوء أبيض أشبه بالمختبر، لكن أسوأ ما في الأمر كان قطرات الدم التي شعرتُ بها وهي تسيل من ظهري. بعد 13 سنة ما زالت الندوب بادية على ظهري."
سعت منظمات غير حكومية محلية ودولية إلى معالجة أوجه القصور في هذا القطاع من خلال عدة وسائل كان من بينها زيارات مفاجئة لتفتيش أماكن الاحتجاز، ومراقبة قوى الأمن الداخلي (الهيئة المسؤولة عن إدارة السجون) من خلال التقارير المنتظمة، والدعوة لضمان توكيل محام ومحاكمة عادلة. في موازاة ذلك، تمول الحكومات الأجنبية الكثير من ورش العمل التدريبية التي تهدف إلى تعزيز المبادئ الإنسانية.
لكن لغاية اليوم لم يحدث الكثير من هذا النشاط. من الأمثلة الرئيسة على التحرك دون إحداث تغيير كان نشر خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان في كانون الثاني / ديسمبر 2013. تضمنت الوثيقة مجموعة من الإصلاحات التي كان مقرراً أن تُنفذ بين عامي 2014 و2019، بما في ذلك بناء سجنين جديدين وإغلاق جميع المنشآت القائمة باستثناء سجن رومية. حتى الآن، لم يُغلق أي مركز احتجاز، ولا يوجد سوى مرفق واحد جديد في مراحل التخطيط وفقاً لمستشار في وزارة الداخلية. في غضون ذلك، أصدر البرلمان في تشرين الثاني / نوفمبر 2016 قانوناً لإنشاء لجنة مستقلة لحقوق الإنسان للإشراف على القطاع، لكن هذه الهيئة لم تر النور بعد.
ضائع في طيّ النسيان القانوني
إن عدم إحراز تقدم في البنية التحتية والتعذيب أمر مثير للقلق، إلا أن التركيز الكبير على هاتين المسألتين قد يحجب مشكلة أكبر، ألا وهي عدم وجود أي إطار قانوني فعال، ما يؤثر على كل جانب من جوانب دورة الاعتقال.
تتضح التناقضات في النظام القانوني في لبنان من المراحل الأولى من الاعتقال، فالاعتقالات تحدث دون صلة تُذكر بالقانون الجنائي أو أي إشراف من السلطة القضائية؛ كما أن الأجهزة الأمنية، التي تظل في حالة تأهب دائم، تسعى إلى فرض القانون والنظام بشروطها الخاصة، في حين تُختزل وظيفة المحاكم عموماً إلى توثيق قرارات هذه الأجهزة. عند الاعتقال، يكون أي افتراض بالبراءة باطلاً عموماً. في هذه الأثناء، أدى تزايد التهديدات الإرهابية إلى تقوية ميل الأجهزة الأمنية إلى ثني حدود القانون أو كسرها، كما أن اللغة الغامضة في تشريعات الإرهاب القليلة في لبنان تجعل من السهل القيام بذلك. على حد تعبير مسؤول بوزارة الداخلية، يمكن بسهولة توقيف شخص في طريقه لشراء الخبز بعد هجوم إرهابي في طرابلس للاشتباه في أنه إرهابي ثم الانتظار أشهراً أو سنوات قبل إطلاق سراحه لعدم كفاية الأدلة.عند الاعتقال، كل افتراضات البراءة باطلة ولاغية عموماً
وبغضّ النظر عن دوافع الاعتقال، يظلّ السجناء رهن الاحتجاز لفترات طويلة دون محاكمة، وتقدر المنظمات غير الحكومية أن نحو 65 بالمئة من جملة المعتقلين هم رهن الحبس الاحتياطي. في بعض الحالات، يُفرج عن الأفراد مباشرة بعد جلسة الاستماع الأخيرة وذلك لسبب بسيط وهو تجاوز مدة العقوبة النهائية قبل إصدار الحكم. ينبع هذا الواقع بدوره من نقص حاد في القدرات القضائية، إذ أشار عامل في منظمة غير حكومية إلى أن بعض القضاة ينظرون فيما يصل إلى 70 ملف قضية في اليوم الواحد، ما يدفعهم إلى إرسال المدعى عليهم إلى أسفل قائمة انتظار مدتها ستة أشهر في حال كان هناك نقص في الوثائق.
وبالتالي يجب فهم الاكتظاظ على أنه نتيجة ثانوية لحقيقة أن قطاع الأمن في لبنان يعتقل أشخاصاً أكثر بكثير مما يستطيع القطاع القانوني التعامل معه. إن بناء المزيد من السجون سيمكن ببساطة الأجهزة الأمنية من احتجاز المزيد من الناس، ما سيضاعف من الاختناق القضائي وربما يجعل الأمور أسوأ بدلاً من تحسينها. في غضون ذلك، تعني الفوضى في المجال القانوني أن التعذيب سيستمر، فحتى يومنا هذا، لا توجد آلية جادة للإبلاغ عن الاعتداءات الجسدية، بل يزعم سجناء سابقون بأن المحامين ينصحونهم بعدم ذكر سوء المعاملة لتجنب استفزاز القاضي والشرطة.
"بالكاد ينظر إليك القاضي، ونادراً ما يطلب الاستماع إلى قصتك؛ فأنت في نظره لست إنساناً حتى، وإن تجرأت على إخباره كيف ضربك الدرك، فما كان ليهتم. إلى جانب ذلك، كان عنصر الدرك الذي صفعني هو ذات الشخص الذي رافقني إلى قاعة المحكمة، ولو أنني تكلمت، لجلبتُ لنفسي المزيد من الضرب منه ومن زملائه."
يغطي الوشم والندوب جسد قاسم، بعضها بسبب الجروح التي ألحقها بنفسه، حسب قوله، لتجنب الضرب. إنه شخص تملؤه الحماسة، ومصمم الآن على مكافحة إدمانه للمخدرات واستعادة حياته الطبيعية، ويضحك من اقتياده سبع مرات إلى السجن في غضون سبع سنوات. غير أن ذلك ترك آثاراً مدفونة عميقاً داخله ولكنها سرعان ما تطل برأسها بين الفينة والأخرى.
الدولة تسحقك سواء كنت داخل السجن أو خارجه، وتمارس هذا الضغط المستمر. أخشى الآن عبور نقطة الدرك أو نقطة تفتيش للجيش رغم أنني لم أرتكب أي ذنب. بمجرد أن يروا الوشم على جسمي، يكفي ذلك لأن يوقفوني. أعيش في خوف دائم من إعادتي إلى السجن بعد قضائي الكثير من الوقت داخله."
وتتعلق طبقة عميقة من عدم الاتساق القانوني بعدم وجود سلطة واضحة ومختصة للإشراف على القطاع وتنسيق عمله. لقد تأخر المسؤولون اللبنانيون عقوداً في نقل المسؤولية من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل، وهو تعهد قُدم لأول مرة في عام 1964 وجُدد في عام 2012. وبطريقة لبنانية صِرفة، تتبادل الوزارات إلقاء اللوم على بعضها البعض بخصوص هذا الطريق المسدود، وفي الوقت نفسه، لا يمتلك أي من الطرفين القدرة اللازمة للإشراف الفعال على قطاع السجون، فوزارة العدل ليست مجهزة بعد لتأمين المرافق، كما أن وزارة الداخلية لم يجرِ تمكينها على الإطلاق للقيام بأي شيء آخر سوى تأمين هذه المرافق، وبالتالي فإن السجون ليست سوى أماكن تحتفظ فيها قوى الأمن الداخلي بالأشخاص الذين تراهم، لسبب أو لآخر، مسؤوليتها إلى أن يتحرك القضاء أخيراً ويتخذ قرراً بالاحتجاز المطول أو الإفراج الفوري.
تماماً كما لا توجد سُلطة مخصصة لهذا القطاع، لا توجد ميزانية مخصصة
يفسّر هذا التعقيد والتشابك المؤسسيّ إلى حدّ ما النقصَ الملحوظ في البيانات الموثوقة والمتاحة للعامة. ليس هنالك رقم مجمع عليه لعدد السجناء في البلد، كما أن المعنيين المطلعين يختلفون حتى على عدد السجون، ففي حين يشير مدير إحدى المنظمات غير الحكومية إلى وجود 25 سجناً في جميع أنحاء لبنان، يقول مسؤول حكومي أن هناك 21 سجناً فقط. يصرّ خبير آخر على وجود 21 أو 24 سجناً وذلك اعتماداً على كيفية حساب الكتل المختلفة في سجن رومية. في عام 2011، دخلت السلطات اللبنانية في شراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لإنشاء قاعدة بيانات بعنوان "باسم" لتخزين البيانات الرئيسة للسجناء، من قبيل تاريخ الدخول والإفراج والسجلات الطبية وما إلى ذلك. لكن يبقى من غير الواضح ما إذا كانت قوى الأمن الداخلي مستعدة أو قادرة على المساهمة بتوفير معلومات ذات صلة. على أي حال، فإن أي أرقام موجودة تحرسها إدارة السجون في وزارة العدل بعناية بالغة.
تماماً مثلما لا توجد سُلطة مخصصة لهذا القطاع، لا توجد ميزانية مخصصة، وبدلاً من ذلك، يجب أن تعمل سجون لبنان وفقاً للظروف الراهنة، إذ تُبنى مرافق جديدة من خلال تمويل استثنائي عادة ما يكون على شكل منحٍ من شركاء دوليين، أما الرواتب فتُدفع من مخصصات قوى الأمن الداخلي، ويُنقل السجناء من وإلى مراكز الشرطة أو قاعات المحكمة باستخدام مركبات ووقود غير مخصص لهذا القطاع على وجه التحديد، كما أن المجتمع المدني مصمَّم للقيام بالعمل الذي يُفترض أن تؤديه الدولة، بما في ذلك توزيع السلع الأساسية مثل الغذاء وفرش الأسنان والبطانيات والملابس.
يعاني السجناء بالتأكيد، ولا يتلقون معاملة حسنة بسبب نقص الوسائل والموارد، وحتى لو أُدينوا لسبب وجيه، فإنهم لا يستحقون العيش في مثل هذه الظروف المزرية." ندى، وهي امرأة تبدو عليها الرصانة والوقار، لا تندم على قرارها الانضمام إلى قوى الأمن الداخلي رغم أنها أُرغمت على العمل كحارس سجن بسبب افتقارها إلى المعارف أو الواسطة.
المشكلة هي أننا نُلام على كل شيء رغم أننا نقوم بعملنا في ظروف مستحيلة. على سبيل المثال، نفتش الطعام الذي يتلقاه السجناء من ذويهم. نفتش كل شيء باستخدام الشوكة ذاتها، وفي النهاية تبدو أطباقهم مقرفة، لكن لا يمكننا السماح للأشياء المخفية بالدخول إلى السجن. ذات مرة ألقوا علينا باللائمة لوفاة سجين لأنه لم يُنقل إلى المستشفى في الوقت المناسب. قال الطبيب الذي قام بتشريح الجثة إن السجين مات لأسباب طبيعية وأنه كان طاعناً في السن وأصيب بأزمة قلبية. يتظاهر كثير من السجناء بالمرض لكي يرسلوهم إلى المستشفيات لرؤية أقاربهم أو ليتمكنوا من الهرب. يجب أن نتأكد قبل اتخاذ الإجراءات، إنها مسألة أمن.
نحن نقف في المنتصف، بين الدولة والسجناء. لا أحد يحبنا ونشعر بالظلم أينما حللنا. الحقيقة هي أننا نعاني بقدر ما يعاني السجناء، فنحن لا نرى الضوء، وأسرّتنا مكسورة، والمراحيض بالكاد تعمل، ولا يُسمح لنا باستخدام هواتفنا. ظننتُ أن المنظمات غير الحكومية يمكنها تقديم الحلول وتحسين ظروف الاحتجاز، لكني أشعر أن الكثير من عملها غير مجدٍ، إذ كل ما يفعلوه هو انتقادنا. يعتقد السجناء والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية أننا لا نؤدي نصيبنا من العمل عندما تكون المهمة صعبة للغاية ومتعبة للغاية. إنه لأمر فظيع، أنت تغرق حرفياً في القذارة."
نظراً لفشل الهيئات الحكومية باستمرار في الوفاء بالتزاماتها، يعتمد قطاع السجون على الجهود المتزايدة من قبل مجموعة من الجهات شبه الحكومية أو غير الحكومية التي غالباً ما تسعى للحصول على تمويل أجنبي لتوفير الخدمات الأساسية، وتقديم المساعدة القانونية، ومراقبة حقوق الإنسان، وإصلاح البنية التحتية المتداعية وما إلى ذلك. زعمَ مسؤول حكومي أن هناك نحو 400 منظمة غير حكومية وجمعية مسجلة اسمياً لدى وزارة الداخلية فيما يتعلق بالاحتجاز، في حين أن اثنتي عشرة منها فحسب، في رأيه، نفّذت برامج مفيدة. جمعية إصلاح السجون اللبنانية هي من المنظمات الهجينة الغريبة التي تأسست في عام 2014 "كمنظمة غير حكومية" من قبل وزارة الداخلية كأداة لجذب الأموال من الخارج، وهي تعكس جوهر النظام حيث تُستخدم أموال المانحين للتستر على أوجه القصور في الدولة.
لقد أثبت المانحون الدوليون رغبتهم في لعب دورهم، مستشهدين بضرورة تعزيز استقرار لبنان وحقيقة أن بيروت - حسب المعايير الإقليمية - على استعداد غير عادي لاستيعاب المشاركة الدولية حتى في المجالات الحساسة مثل الاحتجاز. تلبي هذه المشاركة بدورها الأهداف الغربية المختلفة في مجالات تعزيز المجتمع المدني، وحماية حقوق الإنسان، وكبح المشاعر الراديكالية على نحو متزايد.
يأتي الإصلاح الشامل للعدالة الجنائية في المرتبة الأخيرة على جدول الأعمال رغم كونه المكان الأمثل للبدء
ولكن في ظل الافتقار إلى آليات رسمية لوضع أهداف واقعية واستراتيجية واضحة، تُترك مجموعة مفككة من اللاعبين الأجانب الرسميين وغير الحكوميين للتفاعل كيفما اتفق في سوق الأولويات والمشاريع، وغالباً ما يتنافسون على المكافآت (الأموال والظهور أو حتى ورش العمل في الخارج) بدلاً من التعاون لتحقيق أهداف مشتركة. يقول عامل في منظمة لبنانية غير حكومية بنبرة تشي بحزنه: "حتى بين المنظمات غير الحكومية لا يوجد تنسيق لأنهم يتجاهلون بعضهم البعض. بدلاً من ذلك، هناك منافسة كبيرة فيما بينها، وانعدام ثقة مترسخ، وعقلية "نحن الأفضل!". يخلق النسيان القانوني السائد وضعاً تكون فيه الدولة، بدون سلطة أو ميزانية أو بيانات مخصصة، غير قادرة هيكلياً على تطوير سياسة ما، والنتيجة هي أن الإصلاح الشامل للعدالة الجنائية يأتي في المرتبة الأخيرة على جدول الأعمال بالرغم من أنه يبدو وكأنه المكان الأمثل للبدء.
متاهة من الغرف الثانوية
تؤدي أوجه القصور والغموض العام في هذا القطاع إلى مجموعة من الحلول المؤقتة قصيرة الأمد تتجاوز الاعتماد على المنظمات غير الحكومية والتمويل الأجنبي، ونادراً ما تُناقش هذه الفجوات بشكل متعمق بالرغم من الدور الحاسم الذي تلعبه، والآثار الجانبية الضارة التي يعاني منها الكثيرون.
ومن أوضح الأمثلة على هذا الاتجاه هو اعتماد لبنان المفرط على المحاكم العسكرية، لا سيما منذ إعلان حالة الطوارئ في عام 2012 رداً على ارتدادات الصراع السوري المحتدم. يسمح قانون الطوارئ لقوات الأمن باحتجاز أي شخص يرتكب أعمال الخيانة أو التجسس أو التهرب من الخدمة العسكرية أو الاتصال غير القانوني بالعدو (إسرائيل) أو حيازة الأسلحة ومحاكمته في المحاكم العسكرية، وكذلك أي شخص "يشكل تهديداً أو ضرراً للأمن العام"، وهو تصنيف غامض قد ينطبق على أية جريمة تقريباً، وقد برز هذا الغموض في أواخر عام 2015 عندما أُحيل العديد من النشطاء إلى المحاكم العسكرية لمشاركتهم في الاحتجاجات المتعلقة بانهيار نظام إدارة النفايات في البلاد.
لا توجد مؤشرات تُذكر على احتمال اتخاذ خطوة لإلغاء حالة الطوارئ وتقليص اختصاص المحاكم العسكرية رغم بعض المناقشات التي تدور حول ذلك. على العكس من ذلك، راحت المحاكم العسكرية مؤخراً تتولى حصة متزايدة وروتينية من عبء القضايا الجنائية المتراكمة في لبنان، وهو ما يثير المخاوف بشأن درجة الشفافية في المحاكم العسكرية التي لا تخضع للقيود المفروضة على نظيراتها المدنية، فهي كثيراً ما تستحضر اعترافات تُتزع تحت التعذيب، وتنطوي على فترات أطول من الحبس الاحتياطي، ولا تُظهر أي احترام للحق في الدفاع القانوني أو الاستئناف.
ظهرت مجموعة إضافية من الترتيبات المؤقتة للتعامل مع النقص في البنية التحتية المادية بعد توسع السجون المكتظة إلى مرافق بديلة غير مجهزة البتة لاستقبال النزلاء، وثمة ظاهرة آخذة في التنامي وهي اللجوء إلى مراكز الشرطة المحلية (أو المخافر) كمراكز احتجاز مرتجلة، إذ يقال إن جميع المشاكل الموجودة في السجون الرسمية هي أكثر سوءاً في هذه المراكز.
تدير الأجهزة الأمنية اللبنانية جزءاً كبيراً من مخالفي القانون في البلاد من خلال ترتيبات غير رسمية بحتة
بعيداً عن الهياكل الرسمية، تدير الأجهزة الأمنية اللبنانية جزءاً كبيراً من مخالفي القانون في البلاد - أو ترفض إدارته - من خلال ترتيبات غير رسمية بحتة. قد يتمتع الأفراد بحماية راعٍ قوي ويتحدون القانون، وحتى عندما يتورطون في جرائم عنيفة، لن يجريَ توقيفهم ببساطة ما لم يُرفع هذا الغطاء عنهم. من الأمثلة الشهيرة على ذلك هو إطلاق نار في ملهى ليلي في وسط بيروت عندما أطلق عشرات من أزلام أحد رجال الأعمال المحليين المئات من العيارات النارية لإرهاب رجل أعمال منافس، وقد نجا معظمهم بفعلتهم هذه بأقل العقوبات. كثيراً ما تستفيد الفصائل المسلحة والمجرمون الصغار من الحماية التي يوفرها لهم الساسة الذين يستغلون خدمات هؤلاء في القيام بأعمالهم القذرة.
كما أن بعض القرى تُعرف بأنها ملاذ آمن يمكن أن يلجأ الجُناة إليها، إذا يتواجد فيها مجتمعات مسلحة بشكل جيد يكفي لردع الأجهزة الأمنية عن التدخل، وتحرص على عدم إبراز نفسها بما يكفي لعدم إجبار هذه الأجهزة على التدخل، وبالمثل تدير بعض الفصائل القوية مراكز الاحتجاز الخاصة بها للتعامل مع الأشخاص الذين ترى فيهم مصدر تهديد، فالحركة الشيعية حزب الله، على سبيل المثال، تمتلك قواتها الأمنية الخاصة بها التي قد تختار إرجاء تسليم خارجٍ عن القانون إلى الشرطة، أو حماية شخص من أية مساءلة رسمية، أو استجواب واحتجاز المشتبه به من جانب واحد.
ولعلّ العنصر الأكثر ترسخاً في هذا النظام غير الرسمي موجود في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وهي موجودة، من نواح عديدة، خارج سلطة الدولة اللبنانية. الاعتقال ليس استثناءً، فالفصائل الفلسطينية تدير عملياتها القضائية بنفسها وتحتجز أفراداً لارتكابهم جرائم بسيطة في المخيمات في حين تسلم المجرمين الأكثر خطورة (مثل المغتصبين أو القتلة) إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية. هذه السيادة المحدودة مفيدة للطرفين، فهي توفر لقوات الأمن اللبنانية الوقت والموارد (بما في ذلك مساحة في السجون)، في حين تحتفظ السلطات الفلسطينية بدرجة كبيرة من الحكم الذاتي.
غير أن هذا الترتيب ليس مجانياً، فغياب قوات الأمن اللبنانية داخل المخيمات جعلها، حسب بعض الروايات، بيئات تتساهل مع نشاط إجرامي لا تستطيع القوات المحلية أو لا ترغب في إيقافه. في غضون ذلك، تتبنى الأجهزة الأمنية اللبنانية نهج "الاحتواء" تجاه المخيمات حيث تقوم ببساطة بإغلاق مداخلها استجابة للمخاوف الأمنية، ما يدفع بعض المراقبين إلى وصف هذه المخيمات - ربما مع بعض المبالغة - بأنها "سجون في الهواء الطلق."
الحياة أسفل السطح
وحتى مرافق الاعتقال الرسمية لا تلبي توقعات المراقب الأجانب، فغالباً ما يأخذ الحديث عن السجون شكل غرفة الصدى، فيتردد صداه في نفس نقاط الحديث القليلة دون الاعتماد كثيراً على رؤى أولئك الذين يعرفونها جيداً، وهم السجناء أنفسهم والحراس المكلفون بإدارتهم.
تدور تجربة السجناء، كما يروونها، حول ثلاثة أفكار محزنة
يبدو أن تجربة السجناء، كما يروونها، تدور حول ثلاثة أفكار محزنة. يمكن تسمية الفكرة الأولى "الغطس"، فبطبيعة الحال، عند التوقيف، يُنتزع الفرد من بيئته العادية ويُرمى في عالم مشوش له قواعده الخاصة، عالم يتميز بأشكال متطرفة وعنيفة من التعسف، بدءاً بالحرمان من المساعدة القانونية والزيارات العائلية وجميع أشكال الاتصال الأخرى مع العالم الخارجي، ويتعرض فيه غالبية السجناء الجدد لشتى صنوف الضرب والشتائم والترهيب سواءً كان يشتبه في أنهم قتلة أو متعاطون للمخدرات. يقول أحد المدافعين عن حقوق الإنسان إن كل معتقل مذنب في نظر الدرك ويجب أن يدفع ثمن جريمته المفترضة.
في المرحلة الثانية يُحتجز المعتقلون من بضعة أيام إلى عدة أشهر في زنزانات أو كما تسمى النظارات في ظروف مزرية عموماً. هناك يحصل السجين في نهاية المطاف على إمكانية توكيل محام ويمكن لعائلته إحضار الطعام والملابس له، وفيها تصبح الصلات العائلية بالغة الأهمية وقد تكون السبيل الوحيد لضمان الإفراج عن السجين نظراً لكون المحامين مشغولين جداً لدرجة لا تسمح لهم بالكلام الرسمي مع القضاة المشغولين جداً بدورهم. سيحدد القضاة ما إذا كان ينبغي سجن المعتقل أو إطلاق سراحه وذلك اعتماداً على الأدلة الموضوعية، وكذلك على عوامل ذاتية مثل التحريض من قبل الأجهزة الأمنية أو العلاقات المباشرة مع الطرف المدافع. يقول المثل الشعبي: "المحامي الجيد يعرف القانون، أما المحامي الكبير فيعرف القاضي."
يقاسي النزلاء؛ طوال فترة إقامتهم في السجن؛ الأمرّين لمعرفة مصائرهم، أو متى قد يخلى سبيلهم. وصف سجين سابق شابّ كيف أنه أُرسل إلى سجن رومية، ثم إلى الأمن العام لمدة أسبوع، ثم أطلق سراحه دون سابق إنذار بشأن ما كان سيحدث. كما قال سجين آخر أن عملية انتظار الحكم الذي لا يصدر أبداً هي من بين أكثر الأمور المؤلمة في التجربة بأكملها، وقال إن غالبية المعتقلين محكوم عليهم "بمراقبة باب زنزانتهم يفتح ويغلق طوال اليوم إلى أن يغادروا دون معرفة متى سيكون ذلك." يعلمُ معظم هؤلاء بإطلاق سراحهم قبل يوم واحد فقط أو حتى لحظة حدوث ذلك، ما يخلق حالة من التوقعات المستمرة التي يمكن أن تظل محبطة لسنوات. "احزم أمتعتك، ستخرج غداً"، قد يقول أحد عناصر الدرك فجأة، أو "والدك هنا، سيُطلق سراحك."
تأقلم توني، متعاطي المخدرات الخجول، مثل الكثيرين غيره من خلال إحياء إيمان سابق غائب. "كل من يدخل السجن تراه يؤمن مرة أخرى. يجعلك السجن تشعر أن الجميع قد تخلى عنك. أنت بحاجة إلى شيء أكبر، شيء لن يتخلى عنك، هو الله، وهو ما يساعد كثيراً في تجنيد الإرهابيين. بالنسبة لي، أصبحت الصلاة عادةً في نهاية المطاف، وتوقفتُ عن الصلاة بعد الخروج لأنني شعرتُ أنها أصبحت عملاً روتينياً. ما يؤلمني الآن هو أنني ركعتُ لشيء لا أؤمن به حقاً. لقد كانت شخصيتي محطمة كلياً بعد قضاء شهر في السجن.
تأقلم توني، متعاطي المخدرات الخجول، مثل الكثيرين غيره من خلال إحياء إيمان سابق غائب. "كل من يدخل السجن تراه يؤمن مرة أخرى. يجعلك السجن تشعر أن الجميع قد تخلى عنك. أنت بحاجة إلى شيء أكبر، شيء لن يتخلى عنك، هو الله، وهو ما يساعد كثيراً في تجنيد الإرهابيين. بالنسبة لي، أصبحت الصلاة عادةً في نهاية المطاف، وتوقفتُ عن الصلاة بعد الخروج لأنني شعرتُ أنها أصبحت عملاً روتينياً. ما يؤلمني الآن هو أنني ركعتُ لشيء لا أؤمن به حقاً. لقد كانت شخصيتي محطمة كلياً بعد قضاء شهر في السجن.
ما زلتُ أتذكر آخر يوم لي كما لو كان بالأمس! كان يوم الخميس. جاء والدي لرؤيتي يوم الثلاثاء. بكيتُ كثيراً، وقد تملك الحزنُ والدي لرؤيتي بهذه الحال ولأنه كان عاجزاً عن مساعدتي. قال لي أن أهدأ، وأنه في غضون يومين يجب أن ينتهي الأمر. انتظرتُ يوم الخميس لكنه لم يأت. شعرتُ بالرعب والعجز والذعر، وخطر ببالي أن غيابه يعني أنني لن أخرج من السجن، وأنه كان يخشى أن يخبرني.
الفكرة المؤلمة الثانية في روايات السجناء هي شكل من أشكال "النفي" حيث يؤدي مزيج من أفعال الفرد ومكانته (أو مكانتها) إلى نفيه خارج المجتمع لفترة زمنية غير محددة. في المجتمع اللبناني يوصم من يدخل السجن بعار كبير، إذ يأخذ السجن نفسه هالة الإبعاد التام من العالم الخارجي. يخلق هذا الأمر المحظور نزعة عامة لافتراض أن المحتجزين يستحقون كل معاملة يتلقونها، وهو ما يساعد أيضاً في تفسير سبب عدم إبداء معظم المواطنين العاديين اهتماماً كبيراً بالانتهاكات التي يحفل بها قطاع السجون.
في ظل هذه العزلة، يجد السجناء أسرة في عالمهم الجديد، فزنزانة السجين تصبح بيته والشيءَ الوحيد الذي بحوزته، بينما يصبح السجن مدينته، والطابقُ الذي يقطنه حيَّه. قال أحد المدانين السابقين إن السجن محكوم بقانون من نوعٍ ما: "إنه نظام غير مكتوب ولكنه نظامٌ لا لبس فيه، فإما أن نحترمه أو نصبح منبوذين بين المنبوذين." داخل هذا النظام، كما هو الحال في لبنان عموماً، ينجذب النزلاء نحو التركيبة السكانية المألوفة، أولاً على أساس الدين، ثم المنطقة، وأخيراً الانتماء السياسي. أوضح سجين سابق ذلك بقوله: "من النادر مزج أناس من ديانات مختلفة في الزنزانة نفسها، وعندما يحدث ذلك، تندلع الشجارات. نحن لا نتحدث عن ذلك، ولكن مثلما هنالك انقسام في الخارج، هناك انقسام في الداخل. يجب على المرء أن ينتمي إلى مجموعة ما."في ظل هذه العزلة، يجد السجناء أسرة في عالمهم الجديد
السمة اللافتة لهذا النظام هي احتواؤه الذاتي. في الواقع، وعلى الرغم من الاستثمار الكبير من قبل المنظمات غير الحكومية، يقول السجناء السابقون أنهم تُركوا ليعيلوا أنفسهم بالاعتماد على أفراد الأسرة في إرسال الأموال والطعام والسجائر والملابس والكتب. يعتمد الزملاء في الزنزانة على أقارب بعضهم البعض لإرسال حصص كافية بشكل دوري لجميع السجناء في الزنزانة، وهو ما يحدّ أيضاً من عدد الزيارات التي يتوجب على عائلات السجناء القيام بها.
يتذكر ميشيل، بطاقته المميزة، عملية التكامل: "أنت تتعلم النظام من خلال الألم، فأنت بحاجة إلى شخص لحمايتك. لقد واجهتُ مشاكل صغيرة في البداية، لكني وجدتُ معلمين جيدين. يأتيك الدعم أولاً من مجتمعك الديني، ثم الناس من منطقتك، وأخيراً الانتماء السياسي. هؤلاء هم حلفاؤك.
لكي يتم قبولك في زنزانتك، أنت بحاجة لأن تزورك عائلتك وأن تحضر معها الطعام لزملائك في الزنزانة، وليس لك وحدك. في حال كانوا يحضرون الجبن، يجب أن يجلبوا 500 غرام وليس 100، وإن كانوا يحضرون بيبسي، فعليهم إحضار علبة كبيرة من البيبسي وليس علبة صغيرة، والشيء ذاته ينطبق على الوجبات الجاهزة. القاعدة هي أننا في الزنزانة ذاتها نعتني ببعضنا البعض. إن لم يزرك أحد، فسيطردونك. إنه أمر أشبه بالعيش مع شخص لا يدفع الفواتير أو لا يؤدي الأعمال المنزلية.
زنزانتك تصبح منزلك. ليس لديك أي شيء آخر في الحياة، وما جعلها زنزانتي هو أني بنيتُ الأسرّة والرفوف، واشتريتُ التلفزيون والثلاجة، وركبتُ سخان المياه. لا يمكن لأحد أن يحاول أن يصبح الزعيم في زنزانتي، وإن حدث ذلك فإني أخبرُ الإدارة بنقل الرجل أو أهدد بقتله.
كلما كان الحكم أطول، أصبحتَ أكثر قوة. تمنحك الأحكام الأطول سلطة على النزلاء الآخرين، خاصة في زنزانتك. هناك فرق كبير بين حكم لعامين و 18 عام وعقوبة الإعدام. ما الذي يمنع محكوماً بالإعدام من قتلك؟ ليس لديه ما يخسره."
على النقيض من ذلك، يعبّر السجناء السابقون عن استيائهم من قلة المساعدة التي تقدمها المنظمات غير الحكومية، والتي غالباً ما يصدمهم عملها في اقتصارها على توفير مواد مثل فرش الأسنان أو المناشف. يقول أحد النزلاء السابقين إن تلقي هذه المساعدة قد يساعد بعض الشيء، ولكنها في نهاية المطاف تافهة مقارنة بمدى احتياجاتهم من ناحية، والدعم الذي تقدمه أسرهم أو زملاؤهم من الناحية الأخرى. يرى البعض أنفسهم مجرد سلعة تستخدمها المنظمات غير الحكومية لتبرير حصولها على التمويل. مثل هذه الآراء مبالغ فيها بالتأكيد، غير أنها تسد الفجوة بين ما يحتاجه السجناء وما تستطيع المنظمات غير الحكومية تقديمه.
أما الفكرة المحزنة الثالثة فتتعلق بغياب أي شكل من أشكال إعادة التأهيل ذي المصداقية. الانتقال من الحياة العادية إلى الاحتجاز مفاجئ ووحشي، والعكس صحيح. قد تقدم الدورات التي تنظمها المنظمات غير الحكومية بعض المساعدة في مجالات مثل تعلم اللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو مهارات الكمبيوتر، غير أن سوق العمل للمدانين السابقين كئيب جداً بحيث تذهب جميع هذه الجهود سدى، كما أن المساعدة النفسية آخذة في التضاؤل، وتُقابَل الرغبة التي يعرب عنها النزلاء السابقون للتعبير عن تجربتهم بمجتمع غير راغب بشكل عام في الاستماع لهم، أو غير مستعد لتفهمهم.
كما يُقال على نطاق واسع أن العودة إلى الإجرام متفشية على نطاق كبير بالرغم من غياب أرقام موثوقة. في الواقع، ذكر أحد النزلاء السابقين أن السجون غالباً ما تعمل كدورة تدريبية في الإجرام، حيث يدخل السجين "مبتدئاً" ويخرج "محترفاً" بعد أن يُسجن بسبب سرقة بسيطة على سبيل المثال، وينتهي به الأمر في زنزانة مع مشتبه به في جريمة قتل. في أحسن الأحوال، سيعود الشخص العادي إلى الحياة الطبيعية بعد تجربة مؤلمة حقاً ولا داعيَ لها.
"يقول بعض الناس في السجن: "إما أن تقتل الوقت أو سيقتلك." أي إما أن تدع المشقة تستنزفك، أو تستعيد حياتك وتختار المضي قدماً"، وهو ما فعله إيلي بالضبط، وهو شاب ودود مفعم بالنشاط، ويحمل الشهادات الدراسية بالرغم من قضائه أربع سنوات في سجن رومية بسبب إدمانه للمخدرات.
في السجن لا يوجد ما هو تعليمي أو تأهيلي. إنه مدرسة تعلمك كيف تصبح مجرماً أفضل أو أسوأ، إذ سيصف سجين في الزنزانة المجاورة بالتفصيل كيف سرق سيارة، وسيتعلم منه الجميع، أو تدخله بسبب تعاطيك الحشيش وتخرج منه مدمناً على الكوكايين.
عندما خرجتُ كنت خائفاً. في ذلك الوقت كان السجن عالمي، لم يكن هناك شيء ما سوى ذلك. كنت أحياناً أمضي يومين أو ثلاثة أيام دون أن أغادر زنزانتي حتى لمدة ساعة واحدة، وعندما خرجتُ من السجن، وجدتُ العالم ضخماً! وعندما وصلتُ إلى المنزل في القرية، أخذتني أختي في جولة في السيارة، وبمجرد وصولنا إلى المدينة المجاورة، طلبتُ منها أن تقفل راجعة. كان ذلك كثيراً بالنسبة لي. لم أستطع مغادرة المنزل طيلة أربعة أو خمسة أيام. أخيراً، ذات يوم في الخامسة صباحاً، خرجتُ وحدي لأتجول في الحي وفجأة بدأتُ في استيعاب الأمر كله. لا يمكنني شرح ذلك لك. عندما تخرج من السجن، يبدو لك كل شيء جديداً. فالجسر الذي كان ذات يوم مصنوعاً من الحديد أصبح خرسانياً الآن. افتُتحت مطاعم ومراكز تسوق ومحلات تجارية لم تكن موجودة من قبل. تشعر وكأن الأمر برمته ضرب من الجنون.
يروي الدرك قصة يائسة بنفس القدر تقريباً بالرغم من تحملهم الكثير من اللوم أيضاً على معاناة السجناء، فغالبية عناصر الدرك من الناس البسطاء الذين انضموا إلى الشرطة لعدم توفر فرص أفضل، وقلة قليلة منهم تقدموا بطلب للعمل في السجون. عادةً ما ينتمي أولئك الذين يُرسَلون للعمل في السجون - بسبب ضعف الصلات الشخصية أو ضعف الأداء - للدرجة الأدنى في التسلسل الهرمي غير المعلن لوزارة الداخلية. يقول عنصر سابق في الدرك إن المجندين الشباب لا يتخيلون "أن ينتهي بهم الأمر بالعمل في السجن" لأن ذلك العمل لا يؤدي بهم إلى أي شيء. والواقع أن حراس السجون لم يتلقوا سوى القليل من التدريب بالرغم من كثرة ورش العمل التي تنظمها المنظمات غير الحكومية والشركاء الأجانب والتي غالباً ما يستفيد منها ذوو المراتب العليا وتستتبع الحد الأدنى من التقييم أو المتابعة بعد انتهاء التدريب.
يروي الدرك قصةً يائسةً بنفس القدر تقريباً بالرغم من تحملهم أيضاً الكثير من اللوم على معاناة السجناء
كما يعتبر بعض عناصر الدرك أنفسهم، إلى حد ما، منفيين. قال أحدهم: "نحن معزولون عن العالم، فهواتفنا أُخذت منا، وعندما نريد أخذ إجازة، علينا خوض عملية طويلة ومعقدة تستدعي التوقيع على الكثير من الأوراق." كما وصف عنصر درك سابق آخر كيف سُجن لمدة ثلاثة أيام في مركز احتجاز خاص يُعاقب فيه رجال الشرطة على سوء السلوك بأنه كان أشبه بـ "عطلة تخييم" حيث أمكن له أن يستريح وأن يشاهد التلفاز ويطلب سندويشات الدجاج ويلعب ألعاب الفيديو، في حين أن العمل في السجن أشبه بكونك مسجوناً حرفياً.
يُترجم هذا الوضع إلى تكافل غريب بين المساجين وعناصر الدرك، فمن ناحية، كلٌ يعتمد على الآخر اعتماداً كبيراً، إذ تؤدي مواطن الخلل في هذا القطاع إلى إنشاء سوق سوداء مزدهرة لكل شيء من المخدرات إلى توصيل الطعام أو المكالمات الهاتفية. على سبيل المثال، قد يستخدم عنصر الدرك هاتف السجين المحمول (المهرَّب) للتحدث إلى عائلته في حين يقدم للسجين سلعةً ما في مقابل ذلك.
من الناحية الأخرى، يؤدي غياب القانون في أجزاء من سجون بعينها إلى إساءة عناصر الدرك معاملة السجناء والعكس أيضاً. يقول أحد الحراس الذين عملوا في سجن رومية لمدة أربع سنوات أن عنصر الدرك داخل السجن "يجب" أن يصبح صديقاً للسجناء، أو على الأقل أن يساعدهم في الحصول على ما يحتاجون إليه – وإلا عانى من الإهانات وربما العنف. في أكثر الحالات شدة، قد ترقى هذه الدينامية إلى مستوى أن يأخذ السجناء عنصر الدرك رهينة، وهو أمر متكرر أكده عنصر سابق في الدرك وعضو من الوحدات الخاصة المكلفة باستعادة النظام في حالة وقوع أعمال شغب.
إن أربع سنوات في سجن رومية هي فترة طويلة"، يقول سامر الذي يقف الآن خفيراً في إحدى نقاط التفتيش التي لا تعدّ ولا تحصى في لبنان؛ والتي رُسم عليها العلم اللبناني، وهو يدرك بشكل مؤلم مدى صغر حجم حياته المهنية مقارنة بتلك التي كان يتخيلها. إنه يحصي الأيام لتقاعده ... تبقّت تسع سنوات. "في نهاية المطاف قد تتعرض للتوقيف. إنه أمر مقرف وممل ولا يمكنك العودة إلى المنزل. في بعض الأحيان تكون هناك حالة طوارئ عائلية أو مناسبة خاصة وتحتاج إلى أخذ إجازة لمدة يوم، لكن إدارة السجن لا تمنحك إياها.
ويعتريك الخوف لأن أحداً لن يبالي بما يحدث لك في الداخل باستثناء أقاربك وأصدقائك. ذات مرة هددني إسلاميّ متشدد عرف اسمي وعنواني بطريقة أو بأخرى، فأخبرتُ رئيسي بذلك فوافق على عدم إرسالي إلى الداخل بعد ذلك، لكنهم لم يستجوبوا ذلك الإسلاميّ قط. لقد قمتُ بتعتيم نوافذ سيارتي بعد ذلك تحسباً للخطر.
أخبرتُ والديّ أنني أريد مغادرة سجن رومية. في كل مرة تتحدث فيها وسائل الإعلام عن حادثة ما في السجن، كانت أمي تخاف وتبكي، لكنها لم تستطع الاتصال بي. إنهم وحوش في الداخل، إنهم مجانين. تعرّض عناصر الدرك للضرب والاعتداء والتعذيب وأُخذوا كرهائن من قبل السجناء مئات المرات. في نهاية المطاف تمكنّا من استخدام صلاتنا الشخصية ونقلتُ من السجن.
كل من يعمل في السجن يريد المغادرة. يحاولون جميعاً العثور على الواسطة المناسبة [أو الصلات الشخصية] للخروج لأن العمل في الداخل أمر مروع. أنت تشهد أشياء فظيعة. ذات مرة، أمام وحدتي، جرح سجين كان تحت تأثير الحبوب المخدرة نفسَه بشفرة الحلاقة، ورأينا كيف كانت أحشاؤه تتدلى من بطنه."
مخرج؟
تجسد هذه الديناميات التناقضات الأوسع والمترسخة في السجون اللبنانية التي تتصف بكونها شديدة العزلة ومتصلبة بوحشية ومليئة بالثغرات في آن معاً، ما يجبر الحراس والسجناء على حد سواء على النجاة من خلال اللجوء إلى الطرق الملتوية وذاتِ الارتجال الذي يميز قطاع السجون ككل. يجد غالبية هؤلاء طرقاً مبتكرة للتأقلم والتحايل في ظروف قاسية وتعسفية بشكل لا مبرر له وفي سياق بلد متوسط الدخل.
إن إخفاقات قطاع السجون في لبنان متنوعة ومتجذرة للغاية بحيث تتحدى الحلول السهلة والنقاش والتشخيص المتماسكين. والواقع أن التحديات هائلة: نظام قضائي معطل، وبنية تحتية متداعية، وبيانات غير موجودة، وازدراء مستشرٍ لحقوق الإنسان، وهي تحديات تطورت وتشابكت على مدى عقود، وتفاقمت بشكل طبيعي بسبب الخلل السياسي الأوسع في لبنان. وإزاء ذلك، ليس من المستغرب أن يكافح الفاعلون الخارجيون والمجتمع المدني المحلي لتحقيق تقدم هامشي في السعي إلى الإصلاح بالرغم من وفرة الموارد والخبرة وحسن النية.
ستستمر المشاكل المتعددة التي يقوم عليها نظام السجون في لبنان في المستقبل المنظور، لكن لا يوجد ما يمنع اللبنانيين اليوم من الانخراط في حوار أكثر انفتاحاً وصدقاً حول هذا الموضوع. قد تأخذ مثل هذه المبادرة عدة أشكال: من المناقشات الخاصة بين السجناء السابقين وعناصر الدرك السابقين إلى نشر شهادات مجهولة الهوية من هؤلاء الأفراد. إن عملية إلقاء ضوء جديد على قصص الخطيئة والمعاناة والتضامن هذه تنطوي على إمكانية البدء في إضفاء الطابع الإنساني على قطاعٍ فقدَ كلَّ مظاهر الإنسانية، وقد يفلح هذا التحول الإنساني بدوره بعض الشيء في شفاء الجروح التي يعاني منها آلاف الأفراد الذين يمرون بقطاع الاعتقال في لبنان على أساس سنوي. كما سيساعد ذلك على معالجة أحد أكثر الإخفاقات الجماعية الصارخة في مجتمع يحق له أن يفتخر بانفتاحه وتسامحه، مجتمع قادر تماماً على أن يبلي بلاءً أفضل من ذلك.
30 أيار، مايو 2017
جورج حداد: زميل في سينابس
قام بالترجمة للعربية حسان حساني
تم استخدام الصور بموجب رخصة المشاع الابداعي من: